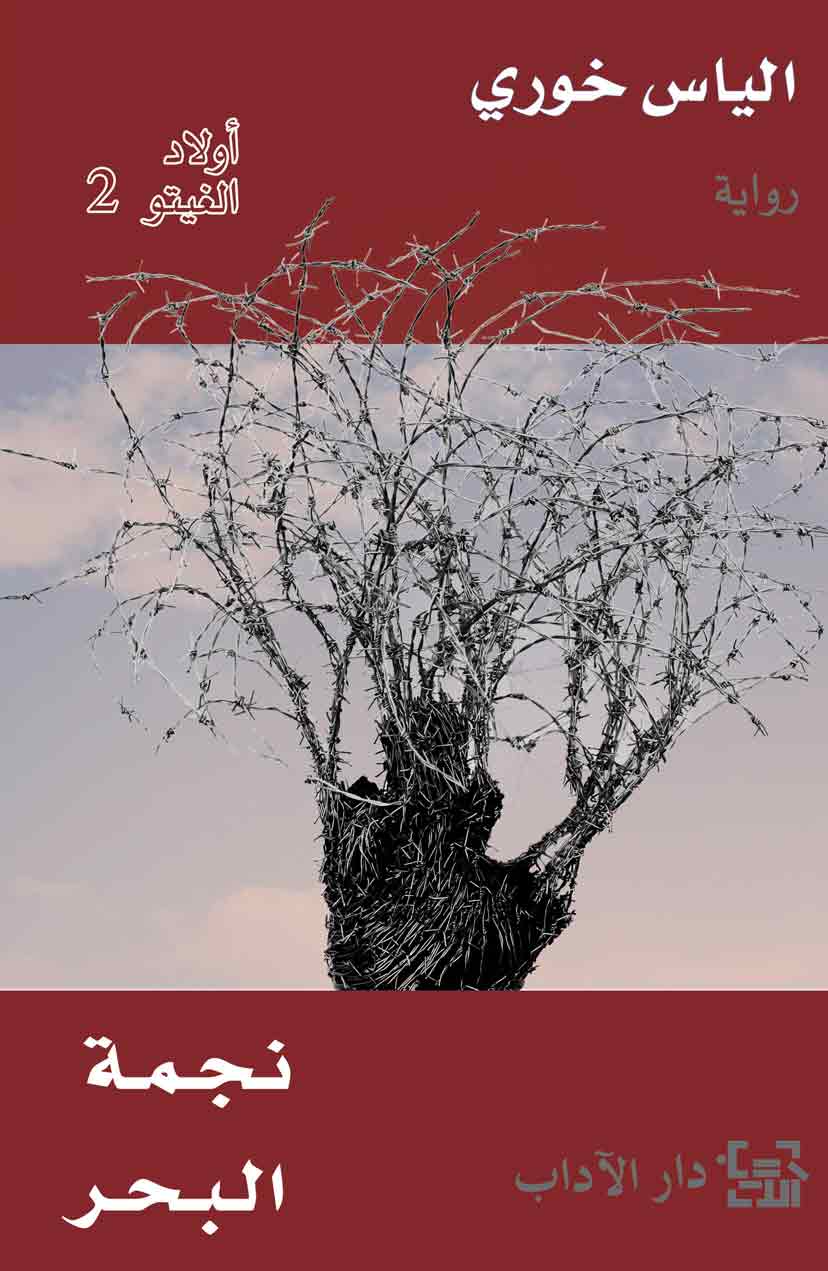بداية، من يعرف الروائي اللبناني الياس خوري، وكان متتبّعًا أعماله العديدة، منذ رواياته الأولى وصولاً إلى “باب الشمس” (1998) و”يالو “(2002)، وانتهاء بروايتي “أولاد الغيتو، اسمي آدم (2016) ونجمة البحر (دار الآداب 2019)”، يدرك أنّ الهمّ الفلسطيني لم يغبْ عن الكثير من أعماله ، علماً أنه ملتزم بسرد كل الحكايات الممكنة وغير الممكنة، وذات الصدقية العالية أو ذات الواقعية الموشّحة ببعض الفكر السياسي (التقدّمي) وببعض التراث الديني والشعري الذي يتفق مع الحبكة الرئيسة التي تتفرّع عنها أحداث وأساطير محلية، في مقاربة خاصّة للكتابة الروائية لا ترى ضيراً من استدخال الشعر في السرد، ولا تجد مانعًا من إعادة صياغة رموز وشخصيات مستعادة من التاريخ ولكن مندمجة في سياقها الزمني المعاصر .
ومن نافل القول إنّ الروائي الياس خوري ما زال أمينًا لعهد – سياسي وأخلاقي – قطعه على نفسه، وتجلّى في كتابته وسلسلة أعماله الروائية التي تعدّت الخمس عشرة رواية ونالت جوائز أدبية عديدة وترجم معظمها إلى لغات أجنبية. ولعلّ هذا ما ينماز به الروائي عن غيره من الروائيين اللبنانيين المجايلين له، والذين قطعوا حبل السرّة مع السياسة وانصرفوا إلى إشكالياتهم المتصلة بمصير الفرد الحرّ في مجتمعه “المتخلّف” والقامع. بيد أنّ الروائي الياس خوري، في ما ارتضى حمله على منكبيه منذ ما يقارب الأربعين عاماً، لم يألُ جهده في تجسيده بأساليب جديدة دوماً، وبلغة روائية تتجاوز نفسها باستمرار، ليس على صعيد الحكاية والتصرّف بالزمن والسرد فحسب، بل أيضاً على صعيد ملامسة المسائل الوجدانية واختبار قدرة الكائن على الانوجاد في مكانين (الولايات المتحدة الأميركية /وفلسطين) ورواية حكاية المصائر – ومن ضمنها مصير الرواي- من خارجها ومن داخلها، حيناً بعد حين (Ubiquité). قبل الدخول في حكاية الرواية التي نحن بصددها، عنيتُ “نجمة البحر”(أولاد الغيتو2)، لا بدّ من إلقاء نظرة موجزة على الرواية التي سبقتها، ويستهلّ بها المؤلف سلسلته بعنوان “أولاد الغيتو”، وهي بعنوان “اسمي آدم”، يعرف القارئ أنه أمام حكاية مغترب فلسطيني مقيم في نيويورك ويستحضر تباعاً مأساته الخاصة (هو آدم بن دنّون، وأمه نوال وأبوه حسن بن علي دنون) قُتل الأب، في خلال الحملة التي شنّها الجيش الإسرائيلي لطرد السكان العرب من اللدّ عام 1948، وكان آدم لا يزال طفلاً رضيعاً، ثمّ تولّى رجل أعمى يدعى مأمون، أبوّته ورعاية أمه نوال، ريثما تنتهي مرحلة الغيتو التي فرضها جيش الاحتلال ومنظماته على الفلسطينيين المطرودين من قراهم ومدنهم في الجليل، في ما يشبه الانتقام من شعب (فلسطيني) وتحميله وزر شعوب أوروبا ونازيّتها التي اضطهدت اليهود وأقامتهم في غيتوات بانتظار إهلاكهم في المحارق. وقد استعاد الراوي الفلسطيني-الأميركي مشاهد مؤسية، في الفصل الثاني منها (أيام الغيتو) تبيّن فيها أعمال القتل والإعدام الانتقائية التي كان يقوم بها جنود الاحتلال إبان سيطرتهم على المدينة، يلازمها حال من تفكك شمل العائلات وانقطاع السبل أمام المتبقين والناجين من المجازر التي يتواصل خيطها عبر الأزمنة والسرد؛ إذ يفلح الروائي بوصل المجزرة الحاصلة في صبرا وشاتيلا، أول الثمانينيات من القرن الماضي، بتلك التي تتفق مع زمن السرد الواقعي، ونماذجه المؤثّرة (رقصة المجنونة لحظة المجزرة، والفرق لجمع جثث القتلى، الخ…). وتنتهي الرواية بمشهد رفع الأسلاك أواخر أبريل (نيسان) 1949 وإعلان الراوي عزمه على “الحفر في ذاكرات الآخرين…” متخلياً عن حكاية الشاعر وضّاح اليمن، ومنساقاً إلى الحكاية التي تلي أيام طفولة التشرّد والمقتلة العميمة.
غلاف الرواية (دار الاداب)
نجمة البحر
وبالعودة إلى الرواية الثانية، في السلسلة نفسها (أولاد الغيتو)، عنيتُ “نجمة البحر” أو ستيلا ماريه، والتي صدرت هذا العام (2019)، فهي تبدأ وقد بلغ الفتى “آدم دنون” الخامسة عشرة من عمره أي من العام1963 وفي هذه اللحظة ينطلق السرد، بل حبكة الترحال بعيداً من منزله، تدفعه إليه أمه نوال، المغلوب على أمرها، إلى جوار زوجها الثالث عبد الله الأشهل، المتعاون مع سلطات الاحتلال. إذاً، يمضي آدم إلى مصيره وحياله ثلاثة تحدّيات، تكوين ذاته بالتعلّم، ومعرفة الآخر اليهودي، ومعرفة نفسه وهويته وتذكّر ما اتصل به من أمكنة ومصائر وأشخاص صنعت وطنه المحتلّ. وها هو الراوي نفسه، والذي بات خارج الحكاية، الأميركي-الفلسطيني المقيم في نيويورك، يستعيد شريط الأحداث التي عاشها، والمحطّات التي اجتازها في أواخر فتوّته: لقاء آدم برجل يهودي يدعى غابرييل تاندروف، في الطريق “بين يافا الناصرة والمجيدل”(ص:35). وقد شاءت الصدف – وضرورات الحكاية- أن يكون آدم شبيهاً بأخ غابرييل الشاب الذي قُتل في إحدى المعارك ضدّ الثوار العرب (!)، ما جعله مقرّباً من البيت اليهودي وعاملاً في ورشة تصليح السيارات التي يملكها غابرييل، إلى جانب العمال العرب زملائه. ولما كان آدم شريداً لا مأوى لديه، أقامه غابرييل في منزل سكّان عرب كانوا نزحوا عنه لحظة العدوان على مدينتهم، في وادي الصليب. وفي هذه الغضون، تنمو الصداقة بين الفتى آدم ورفقة، ابنة غابرييل، حتى تلامس الحبّ وتبلغ خواتيمها حين يفتضح أمر ممارسته الجنس معها، فيُطرد من جنّته الموقتة، وهو في السادسة عشرة من عمره، وقد أنهى سنوات تعليمه (الثانوية) في مدرسة الاستقلال.
ومن ثمّ تبدأ المرحلة الثالثة، وفيها ينتقل آدم ليعيش، موقتاً، في غرفة هي الفرن الذي تملكه عبلة، المرأة الفلسطينية الوحيدة التي تركها زوجها ومضى إلى لبنان، في مقابل أن يعين المرأة على العجين كل صباح.
وهكذا تسنى للشاب ذي السابعة عشرة أن يستهلّ دراسته الجامعية متخصّصاً بالأدب العبري، ويتعرف هناك إلى شخص يهودي يدعى ياكوب إيبنهاينر، متبحّر من اللغة الآرامية والمصرية القديمة، وهو من مواليد برلين من العام 1930. وقد شاءت الظروف، والروائي، أن يكون هذا الشخص محبًّا العرب ويقرأ التوراة على أنها أدب، وليست تأريخاً للشعب اليهودي. ولما كانت توطّدت العلاقة بين الشاب آدم والبروفسور فقد أوصى أن يكون في عداد رحلة إلى وارسو وأوشفيتز من أجل التأمّل في عذابات الأجيال السابقة من اليهود. وههنا يقع التباين، بين آدم الخارج من غيتو اللدّ وبين زملائه اليهود، وتنكشف وجهة نظره التي طالما احتبسها في تلافيف روحه.
“اسمع، يا أستاذ، جئتك إلى هذه الجامعة ودرستُ الأدب العبري لأنني أريد أن أنسى الغيتو، لكنّك مصرّ على تذكيري به. نعم، كانت هناك غيتوات في اللدّ والرملة وحيفا ويافا، وكانت مسيّجة بالأسلاك الشائكة، لكنّكم وضعتم فيها الفلسطينيين وليس اليهود، وأنا ابن هذه الغيتوات. أنا ولدتُ في الغيتو، ولا تزال الأسلاك الشائكة تخزُ عينيّ …” (ص:302)
وتنقضي سحابة التعليم الجامعي ويتخرّج آدم مجازاً، بل أستاذاً بالأدب العبري، ويتعرّف إلى طبيبة أسنان تدعى كرمى سمعان، شابة، علق بحبّها. إلاّ أن الصدف تشاء، مرة أخرى، أن يُقتل والدها أمام ناظري والدتها وأختها، أخت كرمى. وحين يلقى القبض على القاتل، يتبيّن أنه “عبد الله الأشهل” زوج أم الراوي الثاني، وقد تسلل من لبنان ليقتل امرأته الأولى لخيانتها إياه، ولينتزع ابنتيه منها! ثم تتكشّف التحقيقات عن أمور أخرى؛ إنّ الراهبة التي وُجد لديها المسدّس، أداة الجريمة، لم تكن سوى نوال التي لجأت إلى سلك الرهبنة لتقي نفسها شرور أزواجها المتعاقبين!
الملامح الكبرى
باختصار شديد، ما هي الملامح الكبرى، والجديدة التي حملتها رواية الياس خوري الجديدة “نجمة البحر”، وهي الأكبر حجماً من سابقاتها (476 صفحة)؟
أولاً- التزام الروائي بتأثيث عالمه، أعني مسرح شخصياته، ولا سيما الشخصية المحورية “آدم” ومن ارتبط به ارتباطاً خيطياً، في نسجه الأمكنة، داخل فلسطين المحتلّة. وقد استعان لذلك بالعديد من الأشخاص الواقعيين من أمثال: عايدة فحماوي ويهودا شنهاف شهرباني، وليلى شهيد، وغيرهم ممن ترد أسماؤهم في الصفحة (475).
ثانياً – سعي الروائي الدؤوب إلى استكمال محاججته الكبرى، وبنيان خطابه المناهض للخطاب الصهيوني العنصري بآخر قادر على إفحام الخصم والعدوّ، بأنّ ما يقوم به حيال الشعب الفلسطيني، ابن عم الشعوب الآرامية الجذور، من تهجير وقتل وحصر في الغيتوات، وانتزاع للملكيات، وقهر للإرادة، لا يعدو كونه تمييزًا عنصريًا باتت الغالبية اليهودية المتنوّرة تأباه وتحذّر من تداعياته عليها. وهذا ما يمكن لي قراءته من خلال تصنيف الشخصيات وخطابها بحسب فيليب هامّون.
ثالثاً-انصراف الروائي عن لعبة الاستطراد، أو استدخال الشعر (حكاية وضّاح اليمن) إلى ساحة السرد، ما دام قد استطاب تنمية شبه عالمه الروائي، بتعبير الفيلسوف بول ريكور، المكان ومسرحه الجليلي، والزمان وحدوده الموثّقة والمتزامنة مع مراحل سيرة الشخصية المحورية، آدم وسهولة التحكّم بالنقلات القليلة بين زمنين: زمن الراوي الأول، وهو الزمن الواقعي، وبين زمن السرد المندفع صعوداً، وبوتيرة سيرة الآخر، يستحضر محطّاتها الكائنة من خارج السرد، غالباً.
رابعاً- سعي الروائي إلى أسطرة الحكاية الفلسطينية، بل إلى بناء نموذج الفلسطيني التائه في مقابل اليهودي التائه، لا بالمعنى الذي قصده الراهب البندكتاني ماتيو بارّيس (1228)، إذ جعل شخصية اليهودي كارتافيلوس تائهاً في الأرض لا يذوق الموت، عقاباً له على مشاركته في قتل السيد المسيح، وإنما بالمعنى الواقعي وما يستدعيه الدفاع عن أعقد قضية وأبسط مأساة في العالم، هي المأساة الفلسطينية .
الياس خوري يناهض الخطاب الصهيوني عبر شخصية الفلسطيني التائه | اندبندنت عربية (independentarabia.com)