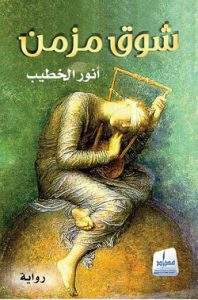الفصل السادس
صلاح
سلام على العابرين
سألني السائق الهندي عن وجهتي فأخبرته، كانت المسافة إلى المطار طويلة جداً، فملأتها أمي؛ تجرأت مرة وسألتها عن كيفية إتمام زواجها من أبي، طفَتْ ورود المراهقة على ملامح وجهها.
مسحتُ بسرعة دموعاً هربت غزيرة، بادرني السائق بلغةٍ إنجليزية مكسّرة ما معناه: (أمي أيضا ماتت، اصبر يا صديق..).
بدهشة: (كيف استنتجت أن أمي مَن ماتت..؟).
بثقة: (لا يذرف الرجل الدمع إلا على أمه..).
شرح لي كيف أنه لم يحضر مراسم حرق أمه، وتجنّب النظر إليها حتى لا يرى وجهها الزجاجي وعينيها المغمضتين إلى الأبد، بل أنه لم يلمسها حتى لا يتسلل بردها إلى روحه.
التقط مربعاً فضّيا يتدلى من رقبته: (هذه أمي.. كانت جميلة تضج بالحياة، تنقل الإحساس بالفرح إلى ناظرها فيبتسم..).
ابتسمت وترحّمت عليها بصوت مرتفع. قبّل الصورة وأقفل المربع الفضيّ: (لكن أمي بوذية!)..
ترحّمت عليها مرة ثانية، نصحني أن أفعل الأمر ذاته، أوصاني ألا أبكيها: (البكاء يؤذي الراحلين، يربك خطاهم وهم يحلقون نحو النور الأبدي..).
غرق وجهه بالدموع فذكّرته بلطف: (ألا يؤذي البكاء الميت؟)،
رد بصوت متقطع: (نعم يؤذيه، أمي ماتت قبل خمس سنوات، ودموعي تبللها وتنعش روحها، أما البكاء قبل الحرق فيؤذي يا سيدي..لا تبك..).
أحيا السائق رغبتي في ممارسة العمل كسائق تاكسي، لا لكي أنقل الناس إلى المطار في طريقهم لدفن موتاهم أو نقل أخبار الفقد، ولكن لأسمع أصواتا غير صوتي، فسيارات الأجرة صناديق الحياة الحقيقية، ولو لملم السائق الحكايا عن مقاعد سيارته لكتب الحياة كما دون زيادة أو نقصان.
قطع السائق شرودي بسؤال مدهش: (هل تمنيت يوماً أن تعمل سائقاً؟ أنا أفرح كثيرا حين أنقل عروسين ذاهبين في إجازة إلى بلدهما، أو شباباً مسافرين للتعرف على دنيا الله الواسعة، ولكن، أرجوك لا تسئ فهمي، أنا لا اشعر بالسعادة كثيراً وأنا أنقل المعزّين والفاقدين، حتى لو أكرموني بمبلغ إضافي، لأنني أعود إلى البيت فورا ولا أخرج منه حتى اليوم التالي، أسلم روحي للنوم، أستيقظ عند الفجر من ألذ ساعات النوم، وأذهب إلى عملي وأنا أترقب سماع قصةٍ جديدة..)
أعطيت السائق أكثر من المبلغ الذي سجله عدّاد السيارة، رفض الزيادة: (أنت أسأت فهمي، أحيانا أواصل العمل على أمل أن يصعد معي عروسان أو شباب مقبلون على الحياة، إن شئت أن تتصدق على أمك فافعل هذا بعد دفنها، ابتسم حين تتذكرها، ستشعر بك، وتقول “ابني سعيد بعدي”، رافقتك السلامة..).
التفتُّ إليه، كان يتأمل المربع الفضلي المتدلي من رقبتي، قبّله، ومضيت.
وضعت حقيبتي في الماسحة الضوئية، بإشارة بسيطة من العامل الأجنبي، خلعت حذائي وحزامي وساعتي، ووضعت الهاتف النقال وعلاقة المفاتيح والعملة المعدنية والذاكرة الإلكترونية في طبق بلاستيكي، دلفت من الباب الإلكتروني فأصدر رنينا، أومأ الشرطي لي بلا اكتراث بتكرار المحاولة، أصرّ الجهاز على رنينه كأنه يغيظني، طلب الشرطي رؤية إثبات شخصيتي، كنت على وشك أن أصرخ في وجهه متسائلا: “وهل الورق التافه هذا هو الذي يعرّف عني وبي؟”، كانت وثيقة السفر الأقرب إلى يدي، مسحني الشرطي بعينيه بحيادية، التقطت فكرةً مرت في ذهنه؛ بوضعي في الماسحة الضوئية، استبعدها حين لاحظ طولي، طلب مني الدخول إلى غرفةٍ خاصةٍ جداً، ونزع ملابسي كلها والمرور من باب إلكتروني داخلي، استجبت دون خجل، قلت في نفسي: (حين يخلع المرء حذاءه يهون عليه خلع كل شيء.. وأمام الجميع….)
رسم الشرطي عقدة وسط جبينه حين أصدر الجهاز رنيناً مرة ثالثة، ربما شك بأمرين: إما أن الجهاز قد أصيب بخرفٍ مبكّر، أو أنني أخفي شيئاً تحت جلدي.
تساءل بجدية كأنه في ورطة: (ما هذا الرنين الذي يصدر منك يا أستاذ صلاح؟).
أجبت بتلقائية: (ربما تجمّع الحزن حول عظامي فأصابها بالتكلّس، لا أعلم..).
قال متعجّباً: (لم أفهمك، ولا يمكن هذا، ولكن لملم أشياءك واستر نفسك وامض إلى أحزانك..).
وضعت حقيبتي على الميزان قالت الموظفة الفلبينية: (وزن حقيبتك أكثر من الحد المسموح بضعفين..). حملت الحقيبة فتحركت في يدي بسهولة، عقدت حاجبيها وطلبت بأدب جم وضعها مرة ثانية، لم يتغير مؤشر الميزان، فتحت الحقيبة بهدوء أعصاب، لم تر سوى عدد قليل من القمصان والثياب الداخلية والجرابات ووصلات كهربائية لشحن الهاتف والحاسوب وغيرهما. زمّت شفتيها الغليظتين واستدعت المشرف، فقام على الفور بحمل الحقيبة، تأملني وطلب منها إرسال الحقيبة إلى الطائرة، قال لها بصوت خفيض باللغة الإنجليزية: (كان في نيّة هذا الرجل وضع كل ملابسه في الحقيبة، كي يسافر ولا يعود..).
لم يكن أحد في انتظاري خارج الدار، الورود المصطفة أمام مدخل البيت صامتة، والقط الأبيض الحزين متجمد في مكانه، الهواء بارد ويحمل معه رائحة الريحان.
ترددت في الدخول، شعرت بأفعى تدخل من قدمي وتتسلل عبر أعصابي تاركة ركبتيّ مخدرتين، وخفقات قلبي تتسارع كصوت إبرة ماكينة الخياطة، تقدمت نحو غرفة أم الفؤاد بخطوات متلعثمة، وصلت الباب. قالت صبية كمن عثرت على أحد مفقود: (وصل صلاح)، وبكت بصوت عال.
غلّف الصمت الجارات والصبايا، شكلت العتبة الحد الفاصل بين الحقيقة والوهم، الغربة والوطن، الحضور والغياب، بين رحمي وأناي، اجتزتها متناسياً قضبان الحديد التي كانت تكبل رئتيّ.
أم الفؤاد ممددة تحت غطاء أبيض مكشوفة الوجه، غادرت الثمانين واستعادت صباها، غابت التجاعيد وحلّ لمعانٌ ساحرُ مكانها، رأيت جبيناً ناعماً كأنه قُدّ من الصباح، وعينين مقفلتين كأنهما زهرتا لوز ستتفتحان بعد قليل، اقتربت من الجسد المسجى كتمثال إلهةٍ مصنوعٍ من الفضة، تحسست وجهها بقلب أبٍ يتلمس نعومة وجه ابنته: (ما هذا الجمال يا أم الفؤاد).
صاحت النسوة الجالسات حول الجسد الملائكي، رفعتُ الغطاء، هممت لأقبل يديها كما كنت أفعل فور وصولي من السّفر؛ تورّمٌ أزرق وآثار حقن التغذية الوريدية، حضرتني صورتها حين اصطحبتها إلى المستشفى، وفشلت الممرضة في العثور على شريان لأخذ عيّنة دم، شكت أم الفؤاد للممرضة: (نشفت شراييني يا صبيّة..).
قبّلت كل مكان دخلت فيه إبرة في ظهر كفها، أعدت الغطاء الأبيض حتى رقبتها: (اتركوني مع أمي بعض الوقت..). عجزت عن نطق بحرف واحد، حضَرني صوت مدرس اللغة العربية وهو يشيد بموضوع التعبير الإنشائي الذي كتبته حول الأم: (ستفرح أمك كثيرا ياصلاح حين تقرأ لها ما كتبت).
هربت اللغة خلسة أمام المشهد القدسي، ذاك المقام كان يتطلب لغة الصوفيين والعشاق الإلهيين، لم أفكر كثيرا في إمكانيات اللغة، همست في سرّي، ورأسي إلى جانب رأسها، وكفّي بكفها:
(سلامٌ عليك ياسلامَ روحي/ سامحيني/ لا شيءَ معي لعينيك المغمضَتيْن/ لا طبيبَ لا دواءَ لا كأسَ ماء/ جئتُ من سفري المؤقّت لأشهدَ هذا الرحيل الطويل المعتّق/ ستخرجين في نزهةٍ أخيرةٍ بعد قليلْ/ لديّ سؤالٌ بسيطٌ خفيفٌ غير مؤلم: ألن تعبري بي؟/ افتحي عينيكِ مرّةً واحدةً قبل عبورِك بي/ اعبريني وقولي كلاما أخيرا لأشهدَ أنك قد بدأت بي وانتهيت بي/ حركي شفتيك طفلتي الكبيرةَ/ الفظي اسمي الصغير بقلبك الكبير/ اذكريني مرّةً واحدة كي أرسمَ المستحيلَ/ قد أغافلُ الموتَ/ أسرقُ منك بريقَهُ/ أدجّنه.. أقايضه/ أقلّها أبادلُ روحَك بي/ والله أبادل روحك بي../ بعد قليل سيقطفك العابرون من شجر البقاء/ يزيّنون السّماء لاستقبالك/ ها أنتِ تعبرين رغم استغاثةِ الطّفل بي إلى مطلق العبور/ وكفّايّ اللذان مسّدا أصابعَ رجليك طويلا سيسحلان كالرماد عن بيتك الخشبي المؤقّت/ هل أتبعك؟/ وددّتُ لو يُشترى الغيابُ لاشتريتُ مضجعَك/ لو أجنّ حتى أخطفَك/ لو تصيرين هواءً لأستنشقَك/ لو أعود طفلا فأبكي وأتبعُك/ وددّتُ لو لم تكوني، كي لا أكونَ فأجهلك/ بعد قليل ستعبرين عبورَ آيةٍ في الرياحين/ سيبكي خلفك الأطفال والرضّع/ القطط العصافير والورد والعريشة سور الدار، بئر الحديقة/ ستعبريننا كلّنا/ سنعود كأنّنا لم نعد/ وحدها عكّازة العمر ستبقى واقفة/ كلّما مسّها أحد يرتجف/ وسبحةٌ تحرك حباتِها وحدها/ تكوِّرُ ذكرَها على تكوُّرِها/ تحاور حبّةٌ حبّة/ تشم عطر كفّيْك وتلتحف/ ونافذة قرب سريرك كلّما أُقفلتْ/ تئن أنينَ السجونِ وتنفتح/ وليلٌ فاقد النطق خارج السور/ لا من يقول: “أضيئوا الطريق للعابرين لينكشف/ فمن أضاء دربك حتى تحجبي الأضواء عنا؟/ وماذا سأفعل؟.. صرت بلا مهنة/ لا شيء معي سوى فضاءٍ يضجُ بالذكريات/ سأفرده، ألملم من زواياه الحكاية/ أؤثّثُ أركانه بعينيك/ لا شيء معي لعينيك سوى عيني، قولي لهما: أضيئا الطريق للعابرين، سلامٌ عليك، سلامٌ عليك، سلامٌ على العابرين..)..
فوجئت بالصبية التي قالت (وصل صلاح) تربت على ظهري، قالت حين استويت واقفا: (سلام على العابرين..).
غطيت وجه أم الفؤاد فبدت كسحابة بيضاء، قرّبت وجهي مرة ثانية من وجهها وشممتها حتى آخر حدود رئتي: (وداعاً يا طفلتي، يا حبيبتي..).
…..
صابر
خالف صلاح وصية السائق الهندي وانفجر باكياً خارج غرفة أم الفؤاد، عانقه أخوه: (كلنا سنموت).
طالما نهشت هذه المقولة العمياء عقله في الصغر، وتركت ثقوباً لم تُقفل بعدُ حتى تلك اللحظة. اشتعلت النار في ساقيه وهمّ بالانطلاق في أزقة المخيم لكنه تراجع، اعتبرها علامة سيئة؛ فقدان الاستجابة لنداء عصبه علامة العجز والشيخوخة والرضوخ لفكرة (كلنا سنموت).
سحب دخان سيجارته ونفثها بهدوء قاتل، استهزأ بقصيدته التي همس بها لأمه، سمعتُه يقول: (الشعر مؤامرة حقيقية ومورفين الصراخ، سكنت روحي بعد ذاك المشهد الكاذب، كأنني بعت أم الفؤاد بقصيدة، كما يبيع الشعراء أوطانهم بقصائدهم الرثة التي تفوح خيانة وتدليسا، كما يبيع المتظاهرون قضيتهم حين يعودون بعد هتافاتهم في الأزقة والشوارع إلى البيوت أو البارات أو المقاهي أو لمقابلة عشيقاتهم كما لو أن مطالبهم لُبّيت، وأوطانهم نُظّفت من الفاسدين، أو كما تنسحب فرقة فنون شعبية من المسرح وتتجه إلى المطعم فيتندّر أعضاؤها على حركات بعضهم بعضا وعلى أخطائهم وأغانيهم الساذجة المكرورة، أو كما يترجل سياسي عن منصة منتفخ الصدر مترع الأحساس بأنه حرر عكا، وكل هؤلاء أيتام ولا يشعرون، وحدك تلوك الفقد يا صلاح، وحدك ترى رحيل أم الفؤاد ثقباً أسود يفتت الفرح وزهو الحياة، وحدك تتمزق للقب “لاجئ”، وحدك لا تتأقلم في الجغرافيا مهما كانت وارفة الطلال عليلة الهواء شهية النساء، وحدك تحيا في المؤقت، بيت مؤقت، فرح مؤقت، سيارة مؤقته، أثاث مؤقت، حتى امرأتك كانت مؤقتة وطلقتك حين أشعرتها بالمؤقت..).
واجهته: (لماذا تتناقض مع ذاتك وقد عشقت نساء بعدد أصابع يديك، حتى أنك تطلق على كل اصبع اسم امرأة عشقتها إلا نجاة، كانت خارج الكفين رغم معاشرتك لها، بينما احتفظ شاهدك باسم زُهرة رغم وهمها، ألا تسكّن بعض قلقي وتستقر، اغضب ما شئت، العن من شئت، لكن عليك أن تعترف بالمعضلة والكارثة والهزيمة وهول المؤامرة، ولا يكفي أن تقول لي ” الشاعر لا يُهزم، سلاحه الحرف الحاد والكلمة العاشقة في القصيدة، والجملة الصاعقة المربكة المخلخلة لنص المشهد في الرواية، وفي الواقع أنت تتعاطى المورفين، وتعاطيته قبل قليل وأنت تحضن جسد أم الفؤاد المسجى..).
لم يجبني، اندفع خارج الدار راكضا كذئب مسعور، سمعته يعوي كأن سكاكين تقطع رئتيه، ولم يعد حتى الصباح. استفسرت عن غيابه فقال: (ذهبت إلى ياسمين، ناديتها وكنت عالم بغيابها، وبكيتها كأنها حقيقة رحلت عن قمة الجبل، وحملت معها قصيدة لم أكملها بعد..)، واقترب من أخيه وأعلمه: (لا تقل ثانية كلنا سنموت، سأعيد أم الفؤاد إلى الحاكورة من جديدة، وستبقى نضرة كعرق الميرمية الأخضر).
…………………………………..