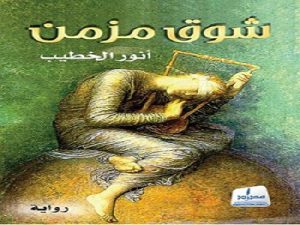رواية شوق مزمن – الفصل الرابع
الفصل الرابع
صلاح
(للأرض لغتها المربكة، ليتنا نبقى في السماء)
سرت خلف المضيفة الشهية نحو مقعدي في الطائرة، لمحت من النافذة البيضاوية الصغيرة امرأة مُسنّة تغطي شعرها بمنديل أبيض، تغادر الحافلة وتتجه نحو السلم، تسارع نبض أمي في عروقي، حضر مشهد أبي خارج المطار، تملكني إحساس أسود؛ لن أعانق أبي مرة أخرى فضاقت نفسي، خففها صوت المضيفة وهي تقرأ التعليمات، أشعرتني أن الطائرة ستتحطم فور إقلاعها، وخشيت أن يوجهوا التهمة لي.
امرأة فاتنة في الأربعين من عمرها، كانت تراقبني بطرف عمرها، سألتني عن تعكّر بياض عيني، أجبتها بروح طفل: (ودعت أبي وشعرت أنه وداع لا لقاء بعده، هكذا بكل بساطة، قد لا نلتقي ثانية، تخيلي؟!)، ردت: (نعم، أتخيل..).
شرحت لها: (أَصرَّ على مرافقتي إلى المطار، لم يتحدث كثيراً خارج صالة المغادرين، ربما تذكر وداعه لأخي الفؤاد..).
سألتني المرأة: (هل تصف أخاك أم تذكر اسمه؟).
ابتسمت: (ذكرت اسم أخي، ووصفه أيضا..). نظرتُ من النافذة الصغيرة الشبيهة بنوافذ السجون وأسهبتُ: (تنقلتْ نظراته مرارا بيني وبين حقيبتي وحركة السيارات والمسافرين، وفجأة، قرّر إنهاء تداخل الزمن البعيد بالقريب، تقدّم على عجل وعانقني كأنه يعانقني للمرة الأخيرة، شدني إلى صدره كأنه يتوّحد بي، أتذكر الآن مقطعاً من قصيدة لشاعر اسمه صابر عبدالنبي يقول فيها:
منذُ ثلاثينَ عاما وخمسِ سنين طوال/ وخارج صالة المغادرين/ شدّني أبي إلى رئتيه وأبعدني/ ثم شدّني وشمّني حتّى ظننته أمّي وأبعدني/ مات أبي مُبعداً/ واسمي على قائمة المُبعدين.
كان العناق أطول من عناق أب وابنه، وأقرب إلى عناق صديقين أو حبيبين يخفي كلٌ منهما أمراً عن الآخر، تاركين للغة الدموع والصدرين والكفّين تمارس البلاغة في أقسى تجلياتها، أبعدني دَفعة واحدة لحظة شعر ماء الفراق يبلل ياقة قميصه: (ادخل المطار قبل أن أعيدك إلى البيت، إنكم تفرغون البيت واحدا بعد الآخر، اذهب ياصلاح، حماك الله يابني..”، هل تتخيلين هذا؟).
هزّت برأسها: (نعم، أتخيل..).
تابعت ثرثرتي: (وثيقة سفري كانت ولا تزال تشعرني بالهروب المستدام، كأنني مطلوب لكل أجهزة الأمن في العالم، ماذا يعني أن يحملق ضابط الجوازات بي كالمذعور حين يفتح وثيقة سفري؟!).
لم يكن معي المال الكافي لأتسكع في السوق الحرة، تخرجت حديثاً من الجامعة، ومصطلح الأسواق الحرة يربكني مفردا وجمعا، “الأسواق” تشعرني بالحرج، و”الحرة” توقظ في داخلي بيوت دبابير، تمنيت أن أصبح بعد عام واحداً من هؤلاء المسافرين الدائمين المطمئنين؛ أتجول في “السوق الحرة” بثقة عالية، بلا دبابير ولا إرباك، أجلس في صالة الانتظار دون رهبة، ألاحق وجوه الفتيات الجميلات والمضيفات الأرضيات دون خجل، أدخل الطائرة كأني قائدها، هل يحق لحامل وثيقة السفر أن يحلم بكل هذا؟!
شرحت للسيدة بعد صمت: (كنت في حاجة شديدة إلى الهرب من حضن أبي الأمّار بالعودة، حين وصلت الصالة التي ينتظر فيها المسافرون قبل الصعود للطائرة، كانت تحوم في رأسي وعينيّ ودهاليز شراييني كلمات أشبه بالشِّعر.. هل تتخيلين هذا؟).
سايرتني مبتسمة: (نعم، أتخيل، ولكن ماذا كان يدور في جمجمتك الشابة؟).
تفحصتها بسرعة، كانت تمتلك نهدين عامرين خلتهما قارورتي عسل: (هل تحبين الشِّعر؟)
حضنت شفتها العليا شفتها السفلى: (أحيانا..)، لم أكترث وألقيت:
(عينان مثل عينيّ طيرٍ وحيدٍ داهمه الشتاء فجأة فارتعش/ عينان مثل عيني شاعر متيّمٍ فاجأته لحظة الكشف فالتحف/ عينان تحملان تحليق ناسكٍ قُدَّ من تجلياته فانكمش/ عينان تنحتان مفرداتٍ اشتقّها عصبٌ من مشقّة البوح وانكسف/ عينان ترسمان في المدى جسدين يفترقان ببطء خروج الروح/ يناشدان نصفيهما بارتعاشة ملؤها الرجاء/ بألا يحدثا صوتين عند شرخ التوأمين//
أعتذر، ثرثرت كثيرا، وأقتحمتك من دون مقدمات، صدقيني أنا قليل الكلام، وربما لن تسمعي صوتي طوال الرحلة، شكرا لإصغائك مدام جوزفين..). واجهتني بانبهار: (كيف عرفت اسمي؟).
ابتسمت بحياء: (لست ساحرا، إنه يتدلى من السلسلة الذهبية وتخفينه تحت قميصك الشفاف..).
لم تقل إنه مخفيّ ويكاد لا يُرى: (كلامك لطيف رغم عدم فهمي للشِّعر كما يليق به، يبدو أنك كنت في حاجة للحديث، وإحساسك بالخوف على أبيك طبيعي، أعتقد أن علاقتك به كانت جيدة..).
استنكرتُ فعل الماضي الناقص: (ولا تزال جيدة، بل رائعة، هو ليس أبي فقط، بل صديقي وذاكرتي..).
أرادت السيدة أن توسّع بوابة روحي باستدراجي للحديث: (كيف، ماذا تعني بأنه ذاكرتك؟).
سررت لبدء تفاعلها: ((أبي صديقي، نجلس معا في ظل شجرة التين، لم تكن لنا وإن كانت في “حاكورتنا”، نتمشى سويا في بستان البرتقال القريب، لم يكن مِلكنا، عمل أبي فيه حارسا ليليا لسنوات قليلة، حدثني طويلاً عن ذكرياته في فلسطين، وأحيانا عن علاقته بأمي..).
فرحت السيدة لذكر الأم، استفزتني أكثر: (هل تعني أنه كان يحكي لك عن لحظاتهما الحميمة أو أنه كان يشكوها لك؟).
ذهب خيال المرأة بعيداً جدا، التزمتُ الصمت، تداركت الموقف واعتذَرَت، أجبتها عن الشق الثاني من سؤالها: (لا أحد يشكو من أمي، أشفق عليها.. تلك الطفلة..).
سألتني بدهشة: (أي طفلة؟).
بفرح: (أمي.. طفلة في جسد امرأة متوسطة العمر، أنا أشعر أنها طفلة.. كل ابن يجب أن يعامل أمه كطفله، يعني كحبيبته تماما..).
تأملتْ السيدة وجهي: (هل كنت تشعر ببعض الغيرة من أبيك؟).
ابتسمتُ وأنا أقرأ ما تخفي نظرتها: (أرجوك، تأملني ملياً، هل تعتقد أن بإمكان أحد أن يعاملني كطفلة؟).
بخجل: (إذا كان يحبك حبا جارفا، ويرى الجنة تحت قدميك، لا بد أن يرى الطفلة فيك..).
تورد خداها: (ماذا تقصد بالحب الجارف؟).
أنستني لحظات وداع أبي: (الحب الجارف يا سيدتي هو التعلّق والانجذاب وسمو الرؤية، لا نرى في الحبيب سوى جماله ولطفه وجاذبيته وبراءته، عندما نحب فإننا نحب الطفل في الطرف الآخر، نكتشف فيه ما نحنّ إليه، ونعشقه..).
تنهدت: (أتمنى أن يعاملني أحد ما كطفلة..).
تجرأتُ: (ألست متزوجة؟).
بصوت خالٍ من الحزن: (مات زوجي منذ خمس سنوات، ولم يكن يعاملني كطفلة..).
بصوت يحمل الاحتجاج والخوف: (وأبي لم يكن يعامل أمي كطفلة، هل سيموت؟).
أدهش سؤالي المرأة، كأنها سمعت طفلا يتحدث بلغة الكبار، أو ربما تساءلت عن المنطق الذي يربط موت زوجها بموت أبي، قلت: (زوجك لم يكن يعاملك كطفلة، هذا يعني أن الطفل مات في داخله، وأبي لا يعامل أمي كطفلة، يعني أن الطفل أيضا مات في داخله..)
قالت المرأة بسرعة: (وهل سأموت قريبا؟).
ببراءة: (لا أدري، ولا أعرف شيئا عن الطفل في داخلك، لكنني ألمح في لون عينيكِ توقاً للحب..). تحسست وجهي بكفها الناعمة المرتعشة: (أنت أجمل طفل قابلته في حياتي؟).
طأطأت رأسي بخجل وارتباك، فَتَحَتْ كفها لتصبح ذقني في باطنها، رَفَعَتْ وجهي وقالت: (لا تخجل، وانس المكان الذي نحن فيه، هنا لا يسأل أحد عن أحد، يلتقي الناس في السماء وهم قريبون من أقدارهم، سيفرح أبوك كثيرا حين يعرف أن امرأة مسحت عن روحك الحزن، سيفرح أكثر حين تضع رأسك على كتفي وتنفذ رغبة بداخلك، وتكون ذاتك في هذه اللحظة، أنت الآن طفل جميل، وأنا امرأة لا أقاوم الأطفال الجميلين..).
بارتباك: (أخشى أن أنام، وأترك بقعة على قميصك كما كنت أفعل على ساق أمي، أو أضحك ملء الطائرة، أو أبدأ بقراءة شعري البائس، أنا في أشد الحاجة لأغمض عينيّ، جافاني النوم طيلة ليلة أمس، بقيت محملقاً بسقف الزينكو المعتم حتى الصباح، ربما تعمّدت ذلك، خرجت بعدها إلى الحاكورة..هل تعرفين الزينكو؟)
قاطعتني: (وما الحاكورة؟).
داعبتها: (سؤالك يعني أنك تعرفين الزينكو..هل نزحت قبل ذلك؟).
ضحكت بصوت لذيذ، بدأ الطفل يطل من شرفة روحها. شرحت لها بسرعة أن الحاكورة هي الحديقة الصغيرة الملحقة بالبيت: (خرجت ليلاً فشممت أزهار الجوري والقرنفل وفم السمكة والعطرة والياسمين والميرمية، وجدت للمرة الأولى في أصوات الحشرات وعواء الكلاب البعيدة طقساً دافئاً، كان القمر كبيرا ليلة أمس، لا أدري لماذا قمر المخيمات كبير، هل تعتقدين أن الله متعاطف مع النازحين! واصلت التأمل بالقمر حتى أرى صورة حبيبتي التي لم أقابلها بعد.. هل تعرفين لماذا تزداد رائحة الورود ليلا؟).
سألتْ بلهفة: (هل يعني أنك تحلم بفتاة لم تقابلها حتى الآن؟ تُرى كيف تبدو تلك الفتاة؟).
كالحالم: (لتلك الفتاة معنى الدفء والأمومة، أراها قادمة مع ضوء القمر، مع رائحة الورود في الليل، تغلفني وتتداخل بهالتي، مثل زُهرة تماماً..).
اقتربَتْ وتنفست بعمق حتى خلت رئتيها امتلأتا برائحتي، وقالت كالحالمة: (وماذا بعد.. حدّثني ..).
أوجزت: (حين يكتمل التوحد أرتعش بشدة..).
لم تسأل عن زُهرة، رفعَتْ الحاجز الذي يفصل بين المقعدين، سمَحَت لرأسي بالاسترخاء على كتفها، شممتُ رائحة عطر شهي، أخذت شهيقا طويلا أصاب المرأة بالقشعريرة، همَسَت: (هل أعجبك عطري؟).
بفرح: (شممته أمس حين اقتربتُ من شجرة الغاردينيا..).
امتدحتني: (عواطفك سماوية أيها الشاب، ولغتك أجمل من دموعك، حاول حين تشعر برغبة في البكاء أن تقف أمام امرأة وتقول شيئا، لن تمانع أي امرأة في أن تكون مدى بوحك، أو أمسك ورقة وقلما واكتب، أنت شاعر يا طفلي الجميل..).
أغمضتُ عينيّ وهمستُ بالقرب من أذنها: (سآتي إليك كلما شعرت بالبكاء..).
تداخل شعرها بشعري: (وحين تشعر بالفرح أيضا.. بالمناسبة ما نوع عطرك؟).
شعرت بالخجل والارتباك: (يبدو أن وقوفي مع أبي خارج المطار تحت الشمس جعلني أتعرق..).
شمّتني ثانية: (عطرك يمزج بين الأنوثة والذكورة يا شاعري، له رائحة الزعتر البري الممزوج بعطر العمبر، ما اسمه؟).
كشف لها: (لم أضع عطرا ..).
بعذوبة: (أنت خيل برّي..).
أعلنت المضيفة عن بدء الهبوط التدريجي، استيقظَت السيدة الجميلة ورفعت رأسها عن كتفي، رتبت شعرها ونظَرت في المرآة: (كأن الزمن عاد بي عشر سنوات، أو قل عشرين سنة..إحساس الطفولة رائع..).
شددتُ الحزام: (ليس دائما ..).
أوقفت النظر في المرآة: (أخَفْتَني، كيف؟).
تجنبت مواجهة وجهها المرتبك: (ذات صباح ماطر، استيقظت أمي حزينة وخائفة، لم تنهض كعادتها لتنشر الدفء في البيت، لم يكن بيتنا، لم تبدأ في إيقاظ النائمين وتحضير وجبة الإفطار وهي تنادينا بأسمائنا، سألتها: “ما بك يا أم الفؤاد؟”. قصت عليّ حلماً غريباً؛ كانت تتجول في البستان الذي يحرسه أبي، فظهر لها رجل فجأة من خلف شجرة البرتقال، قال لها إنه يحبها ويريدها لنفسه، خافت وهربت مسرعة باتجاة غرفة الحارس، أصر على ملاحقتها، صرخت باسم أبي قائلة: “أبو القاسم، تعال واحضر بندقيتك معك..”، توقف الرجل عن متابعتها واختفى، لكن صوته ظل يطاردها كالصدى، كان يقول لها: “أريدكِ، وسأحصل عليك، حتى لو ذهبتِ إلى الآخرة، سأحفر قبرك وأخطفك منه، وستزور عائلتك قبرا فارغاً..”. أجهشت أمي بالبكاء كالأطفال، احتضنتها، كانت المرة الأولى التي تلجأ فيها إلى حضني، تشبثت بياقة قميص بيجامتي مرتعدة، هوّنت عليها، وسألتها كمفسر أحلام: “هل جاء أبي ومعه البندقية؟”، قالت إنه حضر راكضا هائجا وأطلق النار في الاتجاهات كلها، بل إنه صوّب بندقيته نحو الأرض ونحو السماء، فاختفى الصوت واستيقَظَتْ. كانت تحدثني وتتشبث بي كطفلة صغيرة، هدّأتها: (أبي يحبك وسيبقى حاميا لك مدى الحياة، هذا هو تفسير حلمك يا أم الفؤاد”. ابعدتْ رأسها: “هل أصبحت مفسر أحلام ياصلاح؟”. بتدلل: (نعم ياابنتى، يا أحلى طفلة رأيتها في الوجود..”. ضحكِتْ كطفلة في عامها الثاني، ونهضتْ لتبدأ رحلة التعب اليومي..).
سألتني السيدة: (أمك جميلة؟).
تحرك ماء عينيّ في مآقي: (أمي أجمل امرأة في الكون..)،
ضغطَت على كفي وتنهدت: (أنت ملاك أم إنسان؟).
استقرت الطائرة على أرض المطار، تنهدت: (للأرض لغتها المربكة، ليتنا نبقى في السماء، ورغم ذلك، سأخالف قوانين اليابسة..)، شمّتني بعمق ثم قبّلتني على خدّي: (سأعمل على خرق القوانين دائما، بلغ تحياتي لأبيك عندما تقابله ثانية، أحب أن أسافر معك مرة أخرى..).
حضر قريبي إلى شقّتي الصغيرة بعد شهرين، نقل لي خبر موت الطفل نهائيا في جسد أبي القاسم، ترك أمي وحيدة، تستعيد لحظات الحُب التي غمرها بها في آخر أربعين يوما من حياته.
حضرتني المرأة الأربعينية التي غفوت على كتفها في الطائرة، قلت وأنا أرفع وجهي نحو صورة أبي في الإطار الأسود: (أحبتك امرأة دون أن تراك، سأتصل بها لأخبرها وصول سلامها لأجمل صورة لرجل ميت..).
خلعت جوزفين نعليها بناء على رجائي، جلستْ في المكان الذي كان يحتله قريبي، طلبتُ منها تبادل الأمكنة، التزمتُ الصمت كما فعل قريبي ساعة دخوله، رفعت وجهي إلى حيث الأب، ارتجفت شفتاي، حاولت السيدة الاقتراب مني لتحضنني، استأذنتها قبل توجيه السؤال: (كيف استقبلت خبر وفاة زوجك؟).
بارتباك: (كنت أمام البحر حين اتصل بي قريبي في المهجر، قذف في مسمعي الخبر بعد مقدمة تقليدية باردة، تسللت جمرة إلى تجاويف رأسي كلها، أقفلتُ الهاتف وهو يتكلم، تسمّرت قبالة البحر، كانت الشمس تودع عالمي الصغير، لم أبك، لم أشد شعري ولم ألطم، أسلمت روحي للصمت المجبول بالصدمة حتى غابت الشمس، مرت ساعتان وأنا في قلب الظلمة، لم يدخل سمعي سوى صوت تكسّر الموج، نهضتُ بعدها وعدت إلى المنزل، واجهتني صورة حفل زفافنا، انفجرتُ باكية، شعرت بالوحدة تلوكني، اقتاتت عليّ طيلة الليل، وفي الصباح، وضعت شريطاً أسود حول الصورة، وشعرت أنني مت معه، ولم أبك منذ ذلك اليوم..).
كان الحزن ينزّ من ملامح وجهي: (منذ غرق أخي وأمي تكره البحر، لم تتجول وحيدةً على شاطئه في يوم من أيام حياتها، عيناها الزرقاوان تذرفان الدموع الآن، لا توجد صورة في البيت تجمعها بأبي، وليس في ثقافتها إحاطة الصورة بشريط أسود، تُرى ماذا تفعل أمي الآن وليس لديها صورة تجمعها بأبي؟).
وقفتُ أمام صورة أبي القاسم وخاطبته: (لماذا لم تترفّق بها أيها الصديق، كيف استطعت إغلاق عينيك عن عينيها الزرقاوين؟ لماذا يتّمْتَها بصمتك الأبدي؟ لمَ لمْ تدللها في حياتك؟ لماذا لم تذهب بعيدا وتموت؟ لماذا بقيت في البيت أو في المستشفى ترسم أنفاسك هنا أو هناك؟ كنتَ قاسيا ياأبا القاسم، أنت تعلم ذلك، لكنك الآن أكثر قسوة، رمّلت رفيقتك فجأة، ويتّمتني سريعاً يا صديقي، لماذا لم تنتظر حتى أرسل لك نقوداً من تعبي، ياصاحب الإطلالة الأميرية، والروح التي تنافس روح النسر، يا زيتونة القلب وسروة الحياة وزهر الليمون، ياصوتي الخافق في الغيم، لمن أزف أخباري الآن؟ وأمام من سأتباهى بنجاحاتي القادمة، ومن سيطلب لي يد حبيبتي للزواج؟ وفي ثياب من سأشم رائحة الزعتر الأخضر؟ ومن سيقص عليّ الحقيقة التي دفنها المهزومون؟ من الذي سيحضنني حين أعود من منفاي؟ صورتك هذه سأبدل إطارها الأسود بإطار أخضر، حين اخترت لها إطاراً أسود لم ينتابني رحيلك، أرفض غيابك أيها الحبيب، سأحكي عنك لحبيبتي التي ستهطل علي مع ضوء القمر اليتيم، وحين يتجسد الضوء في فتاة سأسألك عنها، وارجو أن تجيب أيها الحبيب..).
اندفعتُ نحو الصورة، انتزعتها من إطارها الأسود واحتضنها، ثم عرضتها أمام المرأة: (هذه السيدة تهديك سلامها، وتحييك، لا شك أنك تشعر بالفرح الآن لهذه التحية أيها الأنيق.. أعلم أنك كنت تحب النساء أيها الشقي..).
احتضنتني: (هل تذكر حين وضعت رأسك على كتفي في الطائرة؟ ضعه الآن في حضني ونم، سأمسد شعرك طوال نومك ياطفلي الجميل..).
استسلمت لحضن المرأة، مسدت شعري بأنامل مرتعشة، نقلت يدها إلى جبيني ثم خدي فأنفي، ثم تركت شاهدها يمر على شفتيّ ويتسلل بخفة إلى رقبتي ثم صدري، أمسكت كفها وقبّلتُه، تنهدَتْ بعمق، غيّرتُ وضْعَ رأسي حتى قابل وجهي وجهها، أحنت ظهرها قليلا حتى لامس صدرها خدي، وضعية أم ترضع وليدها، شعرت بطاقة دافئة وتحرك الطفل المشاغب في ثيابي، استعذبت إحساسي، دسست وجهي أكثر بين نهديها، مددتُ كفي لتلامس شعرها ثم خدها، قبّلتْ يدي مرةً ثانية، سالت منها دمعتان ساخنتان: (كم أشعر أنني طفلة الآن.. ياطفلي الجميل..).
سألتها وأنا ألملمني: (منذ متى لم تمارسي طفولتك؟).
بخجل طفلة: (منذ ست سنوات، منذ سافر ولم يعد..).
بتعجّب: (هل أعادوه من غربته؟ هل هو بعيد؟ لماذا لم تحضريه إلى البيت؟).
بيأس: (نعم أعادوه، تبعد داره عن بيتي عشرة كيلومترات، ثم كيف تريدني أن أحضره؟).
ركزت نظراتي على عينيها: (تسيرين إليه على قدميك، وتسألينه إن كان يحب العودة إلى البيت، سيوافقك، فتفعلين ما فعلته بصديقي مصطفى..).
استفسرتْ: (وماذا فعلت بصديقك؟).
شرحت لها: (كان صديقي الوحيد، ذهبنا معاً لنصبح مقاتلين لنحرر وطننا، كنا في بداية مراهقتنا، تدربنا أسبوعين على السلاح والقفز فوق النار، ثم قررنا العودة، تذرعنا بالمدرسة ومتابعة تعليمنا، بعد عام مرض صديقي ومات، لم أستوعب رحيله، مشيت في جنازته، ابتعدت حين بدأوا طقس وضعه في حفرة باردة، عدت مسرعاً إلى البيت، احتضنتني أمي طويلا: “باستطاعتك الاحتفاظ به حيا في روحك، تواصلان السهر معا، ومراجعة دروسكما معاً، والحديث عن الفتيات الجميلات معاً، تنشّقه يا صلاح وأسكنه في رئتيك.. وسيحيا ما حييت”. غادرت حضنها وانطلقت نحو داره الآخرة، اهتديت إليه رغم الظلام، جلست بالقرب من مستطيل تشكل من حجارة صغيرة، استعدت أجمل لحظة عشتها معه، يوم ذهبنا إلى البحر في عصر أحد الأيام، وخرجنا ولم نجد ملابسنا، سرقها أبناء المدينة الأشقياء، انتظرنا حتى بعد مغيب الشمس بساعتين وعبرنا الشارع بسرعة، سلكنا طريق العودة إلى المخيم عبر البساتين، كنا في ملابسنا الداخلية، حولنا الواقعة إلى سخرية، وبقينا نطلق النكات حتى وصلنا الحارة. قال مصطفى: “علينا أن نأخذ نفساً عميقا قبل التوجه إلى بيتينا، حتى نوقف نوبة الضحك..”. كان يستخدم مفردات جنسية نابية لوصف أولاد المدينة، ضحكت كثيرا حتى رأيته، وسمعت صوته الطفولي العذب، شممته حتى تسلل إلى رئتي وسكن في أول زاوية تستقبل دخان السجائر التي كنا نتعاطاها خلسة، نهضت وغادرت المستطيل، وواصلت حديث كأنه يقابلني، أضحك تارة وأصمت تارة أخرى، حتى وصلت بيته، كررت النكتة الأخيرة التي قالها ذلك اليوم، سمعته يضحك، فأطلقت ضحكة مصحوبة بسعال رجل في الثمانين، لم أتخلص منها إلا حين وصلت البيت، وألقيت رأسي في حضن أمي، منذ ذلك اليوم، وصديقي يرافقني في سفري وسهري، وسأحضر له رفيقا يسليه حين أنشغل عنه.. سأعيد أبا القاسم إلى البيت، إلى رئتي..).
بصوت يائس: (وهل تريدني إعادة زوجي بالطريقة ذاتها؟ سيتهمونني بالجنون).
قلت: (تستطيعين لو أحببت، هل أنا مجنون إذن؟).
بسعادة: (أنت أروع من قابلته خلال الخمس سنوات الأخيرة من عمري، هل تعدني؟).
أحتضنت وجهها: (أعدكِ إذا ناديتني، أن أحضر كالبرق ومعي بندقيتي..).
أكملت ارتداء ملابسها، تنشقتني بعمق وهي تعانقني، قبل مغادرتها فتحت حقيبة صغيرة وناولتني قصاصة صحفية: (أعجبتني كثيرا، كأنك كاتبها..).
حين تلتقي امرأة فوق غيم الله
لا تسلها عن اسمها وعمرها وعطرها
فوق الغيم، يستيقظ المسافرون من موتهم المؤقت
يحكون أحلامهم، التي لم يَرَوْها لعابري الضوء
وحين تلتقي صبية في العشرين فوق غيم الله
دعها، حين تنعس، تتوسد ذاكرتك
وإن كانت صبية في الأربعين
اسمح لها، بتشكيل جديلة، من عناق شعرها وشعرك
وإن كانت صبية في الستين
لا تقاومها، دعها تفعل ما تشاء:
كأن، تُضبطُ ربطة عنقك!
وامنح قلبها أكثر مما تسرّبه أناملها
وحين يهبط حوت السماء
تصرّف، كما لو لم يدر حوار على حافة الشروق
فإن ابتسمَت تلك الصبية
ومدت حريرها لمصافحتك
خذها إلى هودج الأرض
واكتب رسالة لأبيك:
“شمّت امرأة عطركَ الأرضيَّ في السماء،
فارض عنّي.
التوقيع: صابر عبد النبي.
……………..
صابر
أغضبني لَما قال للمرأة في الطائرة إنه لم يقابل الفتاة التي يحبها بعد، هل تآمر صلاح في تلك اللحظة على “زُهرة”! ذاك دور لم أفهمه على وجه الدقة، فالمرأة كانت تكبره بعشرين عاما، لماذا يقدّم قلبه دائما فارغاً من النساء، كأنه يغري من يتحدث إليها بالدخول والسكنى. سألته: (لماذا ادعيت أنك لم تقابل حبيبتك بعد؟)،
أجابني: (تهرب الفكرة عندما يتجسّد المعنى، وتتلاشى النساء الصغيرات مع سطوع الناضجات..).
حاولت ثنيِهِ عن الاتصال بالمرأة فغضب وألح: (أحتاج الآن إلى امرأة حقيقية، تمتلك جهاتها وعمرها، ولها مدى يحتوي مداي، امرأة لها ثديان معتقان منقوعان بنبيذ الأديرة، وحضن أم يحتمل الاحتواء والدموع، امرأة محترفة الانصات، تفهم معنى الفقد، تعطيك ما لا تتوقع، وتمنحك ما يناسب في اللحظة غير المناسبة، لو لم تأت جوزفين لخرجت إليها شاهرا صوتي، لكنها أتت، وعدتني وأوفت، وشاركتني غياب أبي القاسم إذ غيّبتني في حضنها..).
لم يقنعني، واصلت الظهور له وتأنيبه وطرح الأسئلة بغضب، حتى تخلص مني بالانطلاق نحو كورنيش البحر، هنالك ركض كخيل بري، تحاشى الناس بحرفية عالية، ثم اندفع وألقى نفسه في البحر. كان الوقت مساء، اعتقد الناس أنه يحاول الانتحار فتجمهروا على الشاطئ، خرج بعد دقائق والماء المالح يقطر من شعره وثيابه، وتمدد على الرمل وسط دهشة الناس.
فتح عينيه بعد إغفاءة لا أعرف كم طالت، وجد شابا أسمر طويلا كنخلة يقف عند رأسه، سأله: (من أنت؟)
-
(أنا حارس البحر..).الحارس: (أنت لم تعرفني بعد..).همست له حين وصل البيت واستحم وبدّل ملابسه: (أنت سباح ماهر، ولست في حاجة لحراس البحر كي ينقذوك).
-
حذّرني: (سمعتك تنهيني عن القفز في البحر، لا تفعلها ثانية حتى لو قررت الدخول إلى بطن حوت، والبقاء هناك حتى قيام الساعة، لم ينجح الأنبياء مع الناس يا أناي بعد..).
-
صلاح: (أعرفك جيداً، أنت صديق الغرقى..).
-
صلاح: (أرغب بصداقتك، هل توافقك؟).